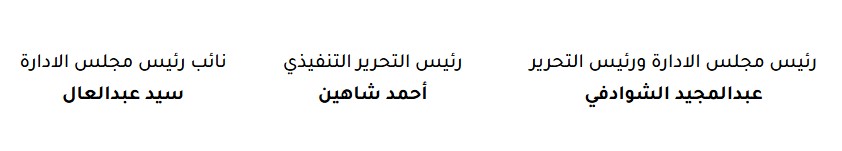كيف استثمرت إسرائيل 7 أكتوبر لتعيد صياغة الإقليم؟

قرأ البعض ثغرة السابع من أكتوبر كفشل استخباراتي كلاسيكي وغرور مهني وثقة زائدة بقدرة الردع، والاعتقاد أن غزة أخضعت بالحصار والتكنولوجيا، لكن القراءة الأعمق تفترض أن إسرائيل لم تكن فقط عاجزة عن التقدير، بل كانت موضوعياً في حاجة إلى “الصدمة” التي يقدمها حدث بهذا الحجم. فبعد عقود من الستاتيكو الذي أبقى الصراع الفلسطيني في إطار إدارة أمنية محدودة، جاء الهجوم ليمنح القيادة الإسرائيلية المبرر لفتح مسارات جديدة.
ليس من الداعي القول إن يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، أو ما عُرف بـ”طوفان الأقصى” غير قواعد اللعبة في الإقليم، وشكل صدمة أمنية غير مسبوقة لإسرائيل. لم يكن ذلك اليوم مجرد هجوم، بل كان بمثابة كبسة زر قلبت جداول الزمن الاستراتيجية في المنطقة، وأعادت تعريف ما يسمى “قواعد اللعبة” بين الضامن الأمني والإقليمي، فحولت أزمة مفاجئة إلى سباق أمني وسياسي مفتوح. وعمل ذلك اليوم كصاعق، فالصدمة الأولية لم تقتصر على الخسائر البشرية والمادية داخل إسرائيل فحسب، بل أعادت فرض أولوية الأمن القومي على الساحة الإسرائيلية والسياسات الحكومية، محولة النقاش الداخلي من قضايا مثل الإصلاح القضائي إلى “حاجة وجودية” تبرر تعبئة شاملة وإجراءات عسكرية واسعة النطاق.
على مستوى المنطقة، أدى الحدث إلى تسريع ديناميكيات تصعيدية متعددة الأبعاد، فإسرائيل لم تكتف برد عسكري على غزة، بل سعت إلى ترسيخ قواعد أمنية جديدة عبر منطق المسؤولية الأمنية الدائمة، والهندسة الديموغرافية، وتوسيع مساحات المواجهة أو الضغط على جبهات أخرى، من الضفة إلى لبنان، وربما أبعد، ذلك أن تلك الحرب أمنت لها غطاءً سياسياً داخلياً وإقليمياً للتحرك بلا قيود سابقة.
على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، أجهضت الصدمة مسارات التطبيع أو التفاوض التي كانت قيد البحث، وأدخلت اللاعبين الإقليميين والدوليين في حسابات جديدة، إعلامياً وسياسياً، وانتهت محاولات فصل القضايا الإنسانية عن السياسات الاستراتيجية، وبدأت مفاهيم مثل التدخل، الحصار، وإعادة البناء، تعاد صياغتها ضمن منطق أمني يعطل جهود حل سياسي طويل الأمد.
أما على الصعيد الإنساني، فأحدثت الحرب دوامة كارثية من النزوح والدمار وخلقت وقائع جديدة يصعب تلاشي أثرها، من تدمير البنى التحتية إلى أزمة إنسانية واسعة، تعيد تعريف معايير التدخل الدولي والمسؤولية عن المدنيين، وهو ما بدل أيضاً معايير الضغط السياسي والإداري على اللاعبين الإقليميين والدوليين.
بهذه الصورة، صار السابع من أكتوبر نقطة فاصلة، ليس فقط لأن حادثة عنيفة حصلت، بل لأن الطريقة التي تفاعل بها الفاعلون معها، أي الإسرائيليون، والفلسطينيون، ودول الجوار، والقوى الكبرى، أنتجت قواعد جديدة للصراع لصياغة الأمن وللخطاب السياسي في الشرق الأوسط.
هل فوجئت إسرائيل بالهجوم؟
في السياق ظهرت تحليلات وتكهنات وتقارير استخباراتية وصحافية، إسرائيلية ودولية، تساءلت: هل فوجئت إسرائيل فعلاً في ذلك النهار؟ وكيف تفسر التقارير التي ظهرت لاحقاً وتقول إنها كانت تملك إشارات إنذار، لكنها تجاهلتها؟ وهل كان ذلك التجاهل وليد ثغرات مهنية واستخباراتية؟ أم أنه قرار مقصود بترك الحدث يحصل ليستخدم كذريعة استراتيجية لقلب الموازين وكسر ستاتيكو استمر عقوداً؟
بين “الفشل الاستخباراتي” و”الحاجة الاستراتيجية للحدث”
وكانت التقارير التي تلت هجوم السابع من أكتوبر، من تحقيقات صحافية في صحف دولية مثل “نيويورك تايمز” الأميركية، أظهرت تسريبات من داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تحدثت عن مؤشرات عديدة سبقت العملية، مثل تدريبات لحركة “حماس”، وتبادل رسائل بين خلايا تتبع لها، وحتى تحذيرات من حلفاء إقليميين. ومع ذلك بقيت هذه المعلومات في الهامش ولم تترجم إلى استنفار أو خطة وقائية. وقرأ البعض هذه الثغرة كفشل استخباراتي كلاسيكي، وغرور مهني، وثقة زائدة بقدرة الردع، لكن القراءة الأعمق تفترض أن إسرائيل لم تكن فقط عاجزة عن التقدير، بل كانت موضوعياً في حاجة إلى “الصدمة” التي يقدمها حدث بهذا الحجم. فبعد عقود من الستاتيكو الذي أبقى الصراع الفلسطيني في إطار إدارة أمنية محدودة، جاء الهجوم ليمنح القيادة الإسرائيلية المبرر لفتح مسارات جديدة.
على الصعيد الداخل الإسرائيلي، جاءت “الصدمة” لتعيد تعبئة المجتمع الإسرائيلي خلف فكرة “الخطر الوجودي”، وتبرير قوانين وتشريعات توسعية باسم الأمن.
أما في داخل غزة، فانتقل النقاش من إدارة الحصار إلى “تغيير قواعد اللعبة” وإعادة هندسة الخريطة السكانية والسياسية. وعلى صعيد الضفة الغربية، فبدأت عمليات تسريع الاستيطان وشرعنة البؤر بحجة أن “الأمن أولاً” ولا مكان لدولة فلسطينية.
أما إقليمياً، فأصبح من البديهي الضغط على مسارات التطبيع، لتتم على قاعدة إسرائيلية خالصة، من دون تنازل لفلسطين أو الفلسطينيين.
“الصدمة” التي تحولت إلى فرصة استراتيجية
هنا يصبح السؤال مشروعاً، هل إسرائيل تجاهلت التحذيرات لأنها لم تدرك حجمها؟ أم لأنها أدركت أنها قد تمنحها ما تحتاج إليه لتفكيك ما تبقى من قيود سياسية وأخلاقية على مشروعها التوسعي؟
يجمع الجواب ربما بين البعدين، أن الفشل المهني أعطى الحدث فرصة أن يقع، وسرعة الاستثمار السياسية جعلت الصدمة تتحول إلى فرصة استراتيجية، ولكن مع هذا، لا قرينة موثوقة تثبت أن تل أبيب احتاجت الحدث أو دبرته، لكن ما جرى بعدها يظهر كيف حوله صانعو القرار، بخاصة مع معادلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتيار القومي – الديني، إلى فرصة استراتيجية لدفع أجندة قديمة جديدة، أي إعادة تعريف “أمن إسرائيل” بمعناه الحدودي والديموغرافي والقانوني، وتوسيع السيطرة الفعلية على الأرض، مع تعطيل أي مسار واقعي للدولة الفلسطينية.
وأتت التصريحات العلنية والخطوات الملموسة منذ الأيام الأولى لتثبت ذلك الاتجاه، منها ما قاله نتنياهو، وفي حديث إعلامي مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أن فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد السابع من أكتوبر 2023، وأضاف “لن نسمح بوجود منظمة ملتزمة تدميرنا، وفكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد السابع من أكتوبر…”، وتابع أن “السلام يأتي من خلال القوة، فعندما نكون أقوياء جداً ونقف معاً فإن الاعتراضات ستتغير”. وشدد على أن اتفاقات التطبيع مع دول عربية في المنطقة، والمعروفة بـ”اتفاقات أبراهام”، “حصلنا عليها لأننا تجاوزنا الفلسطينيين”.
من جهته وفي فبراير (شباط) عام 2024، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه لن تقوم دولة فلسطينية طالما نحن في الحكومة، وذلك بعد تقارير أميركية تحدثت حينها عن خطة للاعتراف بدولة فلسطين، في إطار خطة للسلام. وأشار بن غفير إلى أن “نية الولايات المتحدة، مع الدول العربية، إقامة دولة إرهابية إلى جانب دولة إسرائيل هي وهم وجزء من المفهوم المضلل بأن هناك شريكاً للسلام على الجانب الآخر”، معتبراً أنه “بعد السابع من أكتوبر، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه ممنوع منحهم دولة”. وكتب في منشور على منصة “إكس”، “قتل 1400 شخص والعالم يريد أن يمنحهم دولة. لن يحدث ذلك”.
من الرد إلى هندسة اليوم التالي، كيف انعكس ذلك على الأرض؟
في غزة انتقلت السياسة الإسرائيلية من الرد إلى هندسة اليوم التالي. ومنذ الأسبوع الأول بعد الهجوم، أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستبقى صاحبة “المسؤولية الأمنية الشاملة” في غزة “لفترة غير محددة”، معتبراً أنه “عندما لا نتولى هذه المسؤولية الأمنية، فإن ما نواجهه هو اندلاع إرهاب (حماس) على نطاق لا يمكننا تخيله”. هذا التصريح ليس زلة لسان، بل خط ناظم ينسف السيادة الفلسطينية اللاحقة ويبقي يد الجيش الإسرائيلي مطلقة. وسربت “ورقة تصور” لوزارة الاستخبارات في الـ13 من أكتوبر عام 2023، اقترحت نقل سكان غزة قسراً إلى سيناء، مع رفض خياري عودة السلطة أو نشوء حكومة محلية. وعلى رغم وصفها رسمياً بأنها “ورقة مفاهيم”، فإن وجودها في التداول الرسمي، كشف عن قابلية استثمار الكارثة لفرض تغييرات ديموغرافية دائمة، إضافة إلى أن حملات الإخلاء المتكررة والممرات والإنذارات الأخيرة لسكان مدينة غزة بالرحيل جنوباً، تعكس أن منطق “الأمن أولاً”، يقدم الحركة القسرية للسكان كشرط للعمليات. وآخرها تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأول من شهر أكتوبر الجاري، إذ اعتبر أن أي شخص سيبقى داخل مدينة غزة شمال القطاع “سيصنف من جانب الجيش إرهابياً أو مؤيداً للإرهاب”. وقال كاتس إن القوات الإسرائيلية “تقترب من تطويق مدينة غزة بالكامل”، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حالياً على الجزء الغربي من ممر نتساريم، جنوب مدينة غزة حتى الساحل، ما يعني “تقسيم غزة بين شمالها وجنوبها”، مشيراً إلى أنه “سيشدد هذا الحصار حول مدينة غزة، وسيجبر كل من يغادرها جنوباً على المرور عبر نقاط تفتيش الجيش الإسرائيلي”. من هنا يمكن اعتبار أن السابع من أكتوبر لم ينتج هدف السيطرة الأمنية الدائمة، بل سرع تنفيذه وشرعن أدواته.
وحين كانت عدسات العالم مشغولة بغزة، شهدت الضفة الغربية قفزة نوعية في توسع المستوطنات وشرعنة بؤر وفرض وقائع قانونية وإدارية تقارب ضماً بحكم الأمر الواقع. وهذا ما أظهرته تقارير الاتحاد الأوروبي وحركة “السلام الآن” التي تحدثت عن أرقام قياسية للخطط والمناقصات عامي 2023 و2024، واتجاهاً تصاعدياً مع بداية العام الحالي، والمغزى أن الحرب في غزة أمنت غطاء الزمن والاهتمام لإكمال مشروع “الضم الزاحف” في الضفة وتقويض تواصلها الإقليمي.
“لا دولة فلسطينية” كعقيدة حاكمة
وكان نتنياهو كرر، علناً، رفضه قيام دولة فلسطينية بعد الحرب، وأطر “اليوم التالي” على أساس أمن دائم، لا سيادة فلسطينية. هذه العقيدة ليست ظرفية، بل صارت معياراً لاختبار أي مبادرة، بما فيها المبادرات الأميركية الأحدث. وأتاحت الحرب لنتنياهو إعادة ترتيب أولويات الداخل، عبر تعليق المحاكمات والاحتجاجات، وإعادة لحمة مع اليمين الديني – القومي، وتحويل أجندته الأمنية إلى “حاجة وجودية” تتقدم على كل شيء، حتى في انخراطه الأخير مع “خطة ترمب” لوقف النار والتسوية، هو يوازن بين مكاسب خارجية واسترضاء شركائه