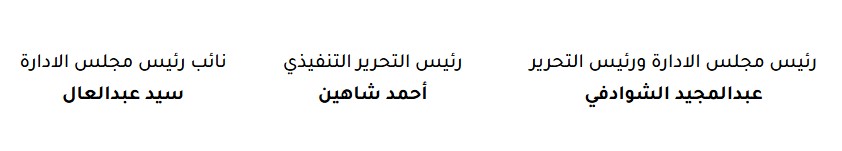المدينة الإنسانية في غزة: بين التصوّر والخيال

المصدر: يديعوت أحرونوت
بقلم: العميد احتياط ميخائيل ميلشتاين (مسؤول الساحة الفلسطينية في شعبة الاستخبارات سابقًا)
هناك رابطٌ بين مشروع “المدينة الإنسانية” المُخطَّطة إقامتها بين خان يونس ورفح، وبين مشاريع آلية المساعدة التي أُنشئت قبل نحو شهرين (GHF)، وبين تسليح الميليشيات التي يُفترض أن تُشكّل بديلاً لحركة “حماس”، إلى جانب الإيمان بإمكان فرْض نزْع التطرف عن سكان غزة. معظم هذه الخطوات تُدفع قُدُماً في جنوب القطاع، وهي المنطقة التي يُفترض بها أن تكون المحرّك لتغيير القطاع بحسب رؤية ترامب، وجميعها تستند إلى الفرضية القائلة بإمكان هندسة الواقع والوعي عبر الدمج بين القوة العسكرية والروافع الاقتصادية.
وبذلك، تترسّخ غزّة كعاصمةٍ للخيالات الإسرائيلية، وحقل تجارب لا يتوقّف عن إنتاج أفكارٍ واهية تفشل بعد وقتٍ قصير من إطلاقها، ويبدو أنّها لا تُرافَق بنقاشٍ عميق ونقدي. إن الصدام المكثّف الذي تعيشه إسرائيل على مدار الأشهر الواحدة والعشرين الأخيرة يُنسي كثرة الأفكار التي تمّ الترويج لها ثم تلاشت، ولا يتّضح فشلها إلاّ عند النظر إلى الوراء، إذ تعكس فهماً مشوَّهاً ومتطرّفاً للواقع: بدءاً من الإيمان بأنّ مزيداً من القوّة سيؤدّي إلى تليين موقف “حماس” أو حتى كسره، أو سيدفعها إلى إعلان الاستسلام، وترْك سلاحها، ومغادرة غزّة، وإطلاق سراح الأسرى، مروراً بمحاولات إنشاء “فقاعات” يُؤسَّس فيها نظامٌ جديد، وانتهاءً بخطة الجنرالات، التي رافقتها حملة شرسة خلت من إنجازات دراماتيكية في شمال القطاع عشية وقف إطلاق النار السابق.
وجميع هذه الأوهام، ولا سيّما الأخيرة منها، تجسّد في الواقع بذور التصوّر الذي انهار في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي يتمحور حول الإيمان بإمكان إخضاع الأيديولوجيا عبر الاقتصاد، وهو ما يعبّر عن تقدُّم ضئيل، إن وُجد أصلاً، في فهم القطاع عموماً، وحركة “حماس” بصورة خاصة. أولئك القادة الذين روّجوا لهذا التصوّر ويُعيقون التحقيق في جذور الإخفاق يواصلون تشكيل الواقع، بينما لا تزال بقايا هذا التصوّر راسخة في أذهانهم، وهذا ما يؤدّي، بصورة غير مفاجئة، إلى التمسّك بالافتراض القائل إنّ الوعد بتحسين الوضع المادي كفيل بإقناع الناس بالهجرة من غزّة أو الانتقال إلى مدينة من الخيام، وأنّه إذا ما تمّ تزويدهم بصناديق غذاء، فيمكن بذلك تغيير تصوّراتهم للعالم.
وتتمثّل هذه الأفكار بتأثيرٍ عميق بأنماط تفكير مصدرها الولايات المتحدة، ولا سيّما الإيمان المفرط بالتفاؤل بإمكان تغيير قلوب الناس من ثقافاتٍ أُخرى وعقولهم، عن طريق المال والإكراه، وكلّ ذلك على أساس منطقٍ غربي، من النوع الذي انهار في فيتنام، والعراق، وأفغانستان. في إسرائيل، يبدو أنّ هناك إصراراً على عدم التعلّم من دروس الآخرين، بل أيضاً من تاريخنا؛ فروابط القرى في الضفة، ورعاية العلاقة مع الكتائب [اللبنانية]، والمصير البائس لجيش لبنان الجنوبي، والطريقة التي نشأت بها حركة “حماس”، كلّها دروس بالغة الأهمية من الماضي، ويُشَكّ في أنّ صنّاع القرار قاموا بتحليلها عندما قرّروا بحماسة وثقة الترويج لمشاريع عديدة في غزّة.
وفي الخلفية، تقف مشكلة أساسية مستترة وغير مطروحة بما يكفي في الخطاب الإسرائيلي بشأن غاية الحرب في غزّة؛ إذ يبدو أنّ هناك مواجهة بين عقيدتين، إحداهما تتمسّك بالتوجّه نحو ترتيبٍ سياسي، يترافق مع الانسحاب من أراضي القطاع وترْك حسم مصير “حماس” كهدفٍ للمستقبل، والثانية تدفع نحو استمرار المواجهة حتى احتلال القطاع بالكامل. وترافق الفرضية الثانية مبرّرات يُفترض بها أنّها استراتيجية، كـ”العرب لا يرتدعون إلاّ بفقدان الأرض” أو “الاستيطان يمنع ’الإرهاب‘.”
لقد حان الوقت لإزالة الأقنعة، فالفرضية الثانية ليست في الحقيقة استراتيجيا مُحكمة، إنما تُعبّر في جوهرها عن رؤى أيديولوجية وإيمان بتحقيق الخلاص عن طريق السيطرة على أرض إسرائيل بالكامل. وفي الخلفية، يُسمع الادعاء القائل إنّ النزعة المسيانية ليست أمراً مُداناً، لأنّ “بن غوريون أيضاً كان مسيانياً.” وكلّ ذلك من دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ بن غوريون، على الرغم من أنّه صاغ رؤية وتمسّك بها، فإنّه كان حصيفاً بما يكفي لتجنّب التطرّف الأعمى، وعرف، على سبيل المثال، كيف يتوقّف سنة 1949 عن احتلال البلد بالكامل، أو ضمّ قطاع غزّة، إدراكاً منه للتبعات السلبية لخطوات كهذه، وعلى رأسها الإخلال بالتوازن الديموغرافي داخل إسرائيل.
كل ما ذُكر يأتي في الوقت الذي يُشَكّ فيه إذا ما كانت أغلبية الجمهور تؤيّد هذه الأهداف أو حتى على دراية بها، وذلك جزئياً، لأنّ الحكومة تحرص على عدم تقديم شرح معمّق لمسألة تبعات السيطرة على القطاع بالكامل.
وعلى سبيل المثال، فإن ضمان معيشة مليونَي فلسطيني يحملون مشاعر عدائية في منطقة مدمّرة، وواقعٍ أمنيٍ على طراز النموذج اللبناني أو العراقي، يتمثّل في حرب عصابات مستمرّة ستتطلّب تخصيصاً كبيراً للقوات على مدى طويل، وسترافقها خسائر بشرية، بالإضافة إلى انعكاس ذلك في العلاقات مع الدول العربية: إذ ستتحوّل عملية التطبيع إلى حلم بعيد المنال، ومن المتوقّع أن تتدهور العلاقات القائمة، وخصوصاً معاهدة السلام مع مصر.
وحتى لو انتهت الحملة في غزّة بتسوية، وبالثمن الباهظ المتمثّل بوقف القتال والانسحاب من معظم القطاع أو كلّه، فإنّه يَجْدُرُ ألاّ يُدفَن النقاش الداخلي الإسرائيلي الذي أُشعل خلالها، بل أيضاً ينبغي إبرازه ومداولته. والمقصود هو نقاش معمّق بشأن المسألة الفلسطينية، التي تمثّل في الواقع جدلاً أوسع بشأن ملامح إسرائيل: من شكلها الجغرافي، مروراً بأهدافها المستقبلية، وانتهاءً بالأيديولوجيا والثقافة والقيم التي ستقودها. وقد تهرّبت الحكومة والجمهور في إسرائيل من هذه القضايا قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي نهاية المطاف، وقعت هذه القضايا على رؤوسنا جميعاً بصورة مأساوية ومفاجئة، وتبيَّن للإسرائيليين أنّه ليس فقط العلاقة مع الفلسطينيين هي التي ينبغي إعادة مناقشتها، بل أيضاً المسألة المؤلمة والمعقّدة للعلاقة بينهم وبين أنفسهم.