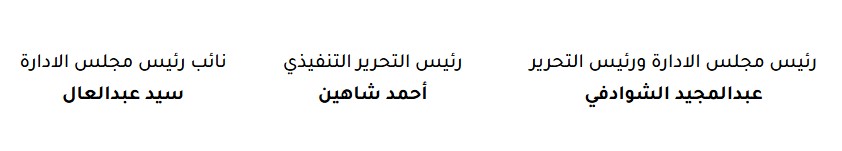ما رآه عزت القمحاوي .. ميتافيزيقا سامي يعقوب


بقلم د. حسين محمود
سامي هو اسم عادي، شائع، ولكن جذوره دينية، فهو ابن نوح “سام” والذي أسس لسلالة الساميين. أما يعقوب فهو اسم توراتي، وهو أبو يوسف، ذلك المهاجر الذي حكم مصر من منطلق ميتافيزيقي يؤمن بالتنبؤ واعتبار الأحلام استشرافا لواقع المستقبل، أو لمستقبل الواقع. لماذا اشرح هذه الأسماء؟ الكتاب الروائي المصري عزت القمحاوي هو السبب، فقبل سنوات نشر رواية قصيرة بعنوان “ما رآه سامي يعقوب” ولم أقرأها حين صدورها، ولكنني قراتها مؤخرا، بمحض الصدفة، فقد التقطتها من مكتبتي في لحظة قررت فيها أن أقرأ، ولكنني لم أقرر ماذا أقرأ.
تحكي الرواية عن شخصية اسمها صيري يعقوب، أبوه كان وزيرا سابقا، وزوجته أجنبية متزوجة من مصري، وابنه اختار حياة وحضارة مختلفة، وابنه الثاني الذي يرافقنا بوجوده طيلة الرواية رغم أنها محكية بضمير الغائب الذي يتماهي فيه البطل مع الرواي، وفريدة هي الأرملة التي عشقها سامي ولكنه – لسبب غائب – لم يستطع أن يستكمل قصة حبه لها. المكان الذي تدور فيه أحداث الرواية هو ميدان التحرير، فبيت سامي في جاردن سيتي – على مرمى حجر من الميدان – حتى أن سامي يسمع الأصوات التي تنطلق منه وهو في بيته، وهو أيضا المكان الذي استضاف حادثة مقتل أخيه، والمكان الذي اختاره الأب لكي يحتفل برد اعتبار يعقوب – جد سامي – في حفل مجهض، انتهى قبل أن يبدأ.
وما لفت نظري في أحداث الرواية وجود رموز مثل القطة والكلب والفراشة والشجرة، وهي رموز وجد لها المؤلف حيوات مختلفة، وجعلها ضمن شخصيات روايته، تدخل المشاهد وتخرج منها بطريقة مسرحية. ولفت نظري أيضا أن الأسماء لها أهمية وإلا ما وضعها المؤلف في عنوانه.
وهكذا نجد أن يعقوب وابنه يوسف موجودان في ميدان التحرير، وأن سامي مجرد شخصية ميتافيزيقية تشبه آلهة اليونان، فهو صامت في الغالب، غير منفعل، يرى ما لا نراه وما لا يراه الناس. وحده عزت القمحاوي يعرف ماذا يرى سامي ابن يعقوب، وما الذي أجهض علاقته بالمعشوقة “فريدة” التي مات عنها زوجها، وعشقت سامي في وقت ليس بعيدا عن جنازة زوجها.
الجديد – ربما – في هذه الرواية أن عزت القمحاوي الإنسان استطاع أن يجد أخيرا ضلع المثلث الثالث الذي يكمل دورة الحياة في نظره: الروح (وما يرتبط بها من مفهوم الخلود)، وهي الضلع الذي يتشابك مع ضلعي الموت والجنس لكي يكتمل المثلث. انضمت الروح إلى الجنس والموت، وما كنا نراه هواجس مسيطرة في أدبه – كان كذلك في روايته الخيالية “مدينة اللذة”، وفي ملحمته “بيت الديب”- أصبح في “ما رآه سامي يعقوب” قضية وجودية بامتياز، أقرب إلى الحل في الميدان، وأبعد من مجرد هواجس أديب، فنقرأ فقرة مكتوبة بالبنط الداكن، بمعنى أن المؤلف يبرزها (إن كان له دخل بتنضيد النص)، يصف فيها لقاءات سامي يعقوب الحميمية مع فريدة، يقول: “يشتعلان وينطفئان معا، لكن روحيهما المتشابكتين لا تتركان لهما فرصة الابتعاد، يستلقيان متماسين يتكلمان ويتكلمان بينما تلمع عيونهما بالغبطة. روحه المربوطة بروحها هي التي تدفع أصابعه الشبعانة إلى الاستمرار في تلمس جسدها المفعم بالسكينة. هل الروح خالدة لأنها لا تشبع؟ هل النهم هو التعبير عن ولع الخلود؟ أدهشه انه فهم في لحظة خاطفة كهذه ما لم يفهم من قبل عن نفسه. قال بثقة: “نعم، وهذا النهم للخلود هو ما يجعلني أشتهي صاحبات فريدة”. هذا الرد الواثق بالإيجاب لم تكن الشخصية الدرامية “سامي يعقوب” بحاجة إليه في هذا الموقف، ولكنه المؤلف – عزت القمحاوي – هو الذي رد على تساؤلاته والتي وجد لها أخيرا إجابة.
“صاحبات فريدة” فيها تناص مع “صاحبات يوسف”، وهي أيضا من القصص الديني القرآني والتوراتي، وبالرجوع إلى المصدر نكتشف ان هؤلاء الصاحبات لم يكن لهن علاقة بيوسف، بل إن يوسف في الحقيقة أعرض عنهن، وإنما كن من صاحبات امرأة العزيز التي هم بها يوسف وهمت به هي، في تصوير علاقة حميمة لم تتم خوفا من سلطة الحكم “لولا أن رأى برهان ربه”، والرب في هذه الحالة ليس “الله” وإنما هو رب عمل يوسف، أي عزيز مصر، أي حاكم الإقليم الذي كان يعيش فيه يوسف. فريدة إذن لها علاقة بمصر، إن لم تكن هي مصر نفسها.
إن وضع عزت القمحاوي لكل هذه الشخصيات التوراتية في ميدان التحرير، مع “لخبطة” أدوارهم، كان حيلة روائية تبعده عن القصص الديني والتاريخي، وتجذبه نحو الواقع المصري في رؤية أدبية جمالية مبدعة. فنحن نجد أن رؤى سامي هي رؤى يوسف بن يعقوب، وأن يوسف صبري يعقوب لم ينج من مؤامرة أخوة يوسف بن يعقوب لقتله، وأن العلاقة الحميمية مع امرأة العزيز قد اكتملت، لأن الطرفين رأيا فيها “الغبطة” الروحية والشبق إلى الخلود، ولكنها لم تكتمل مع يوسف وإنما مع سامي الذي يتحول إلى رمز لكل الساميين ولكل من يمتلك القدرة على النبوءة، أبطال ثورة الميدان الذين لا يعرفون مآل ثورتهم التي حيكت حولها أكاذيب، سواء حول شخصية يوسف، أو حول قضية وهمية مثبتة في الأوراق ولكن ليس لها أصل في الواقع اتهم فيها سامي في الفيوم التي لم تطأ قدمه نواحيها. لكي يصبح اللقاء بين أبطال الثورة وفريدة مستحيلا، في نهاية تشاؤمية للرواية، يحس القارئ أنها مبتورة، لأن المؤلف لم يوفر ما يدل على أن هذه العلاقة لابد أن تنقطع. والحقيقة أن “ما بعد الرواية” سيضع شروطا لاستئناف العلاقة، ربما رآها يوسف/سامي يعقوب، ولم يصرح بها، والمؤكد أن المؤلف الراوي رآها وصرح بها، ليس في سطور روايته، وإنما ما بين وما تحت السطور.
وبالمناسبة فالسامية الحقيقية والروائية على حد سواء ليس لها علاقة حصرية باليهود، فهي منسوبة إلى سام بن نوح، وعرفت بها اللغات السامية، ومنها العربية بالطبع، وكان وصف “الساميون” في عصور سابقة هو المرادف للعرب، قبل أن يتلقف اليهود المصطلح في القرن الثامن عشر وينسجون منه أكذوبة “العداء للسامية”، في صراعهم ضد الغرب، وضد العالم كله، إبان وجودهم في أوروبا.
وفي النهاية يمكننا القول بأن ما رآه سامي يعقوب في الرواية هو ما رآه عزت القمحاوي في الحقيقة، وهو ما رآه ملك مصر في أحلامه (وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ)، وفسرها يوسف بن يعقوب على النحو الذي نعرفه من تناوب الأزمات والخيرات ووجوب التجهز لمواجهة الصعاب.
أو أن ما رآه سامي يعقوب كان صعب التفسير بالمنطق الطبيعي، ولذا لجأ المؤلف إلى “ما فوق الطبيعة”، إلى الميتافيزيقا، التي نلجأ إليها عندما تعوزنا القدرة على مواجهة الظواهر الغامضة المستعصية على الفهم. وهكذا اقترض من التراث الغيبي والميتافيزيقي، واستعان برموز مثل “القط الأسود” الفرعوني المرسوم على الغلاف وخلفه وبداخله رجل شبحي وشجرة المقاومة التي تتحمل التشذيب، والتي كلما شذبوها شمخت، ولذا بدا سامي يعقوب شخصية ميتافيزيقية، ولن يمكنه النزول إلى الواقع ما دام هناك من يتربص به، وسيظل خائفا من التفاعل مع محبوبته فريدة – وصاحباتها، محبوباته- حتى لا يسبب لها أو لهن الأذى.