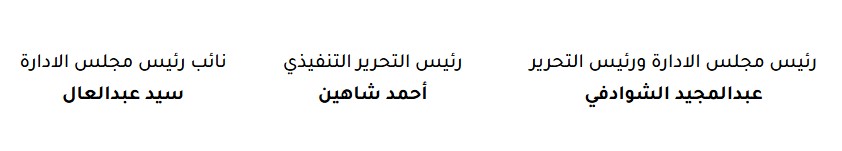اسرار البرنامج النووي الإسرائيلي وعلاقته بالعدوان على غزه

لعل التاريخ لم يشهد على سر معروف للعالم، مثل سر امتلاك إسرائيل لسلاح نووي، فعلى الرغم من السرية والتكتم الشديدين اللذين تحيط بهما تل أبيب تفاصيل برنامجها النووي العسكري، إلا أن الشك لا يساور أحداً من المراقبين بشأن امتلاكها ترسانة نووية يُختلف على حجمها، ولا يُختلف على وجودها.
وعلى الرغم من حرص المسؤولين الإسرائيليين على عدم ذكر أي إشارة في أحاديثهم على مر الحكومات المتعاقبة منذ قيام إسرائيل قبل 75 عاماً بشأن البرنامج النووي أو ترسانة الأسلحة النووية، إلا أن وزير التراث عميخاي إلياهو، وقع أخيراً، في خطأ لا يُعرف إن كان عفوياً أم مقصوداً، عندما دعا إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية.
وبغض النظر عن ردود الأفعال الصاخبة داخل إسرائيل نفسها، وفي العالم العربي، ودول عدة حول العالم، إلى جانب المنظمات الدولية، المستهجنة لتصريحات إلياهو، إلا أن حديثه أعاد إلى الواجهة قضية البرنامج النووي الإسرائيلي، الشبيه بـ”شبح ضخم هلامي الملامح”، لا يُرى بوضوح، ولكن حضوره محسوس على الدوام.
وبحسب مؤسسة التراث الذري، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، فبعد إعلان قيام إسرائيل في مايو عام 1948، لم يضع رئيس حكومتها الأول ديفيد بن جوريون وقتاً طويلاً قبل أن يوجه بتطوير برنامج نووي، وفي العام التالي أجرى الجيش الإسرائيلي مسحاً جيولوجياً لصحراء النقب، حيث عثر على نسبة من اليورانيوم في مناجم الفوسفات.
كما اهتم بن جوريون باستقطاب علماء للإشراف على البرنامج النووي الوليد آنذاك، ووقع اختياره على الكيميائي ذي الأصول الألمانية إرنست ديفيد بيرجمان، ليرأس هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية عام 1952، كما ترأس إدارة البحث والبنية التحتية التابعة لوزارة الدفاع، والتي تحولت عام 1985 إلى هيئة تطوير التسليح “RAFAEL” وكُلفت بتصنيع قنبلة نووية
لم يستبعد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الأحد، إمكانية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، معتبراً أنها “إحدى الطرق” للتعامل مع القطاع.
ومع ذلك، لم يكن بيرجمان هو القائد الفعلي للبرنامج النووي الإسرائيلي، إذ وقعت تلك المهمة اعتباراً من عام 1955 على عاتق مدير وزارة الدفاع آنذاك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد عقود، شمعون بيريز، الذي كان موضع ثقة كبيرة لبن جوريون، ليشكل الرجال الثلاثة، الإدارة العليا للبرنامج النووي الإسرائيلي خلال سنواته الأولى
وكانت الحكومة الإسرائيلية حينها، تُدرك جيداً حاجتها إلى مساعدة خارجية للحصول على قنبلة نووية، ففي عام 1955 وافقت الولايات المتحدة على بيع مفاعل أبحاث تحت رعاية برنامج “الذرة من أجل السلام” إلى تل أبيب، وهو المفاعل نفسه، الذي حصلت عليه إيران، عبر مساعدة واشنطن، لبرنامجها النووي في الفترة ذاتها.
وعلى الرغم من أنه لم يكن مسموحاً لإسرائيل بموجب اتفاق البيع، إنتاج عنصر البلوتونيوم، إلا أن تقريراً سرياً لبيرجمان كشف لاحقاً نية تل أبيب تحويل مفاعل الأبحاث الأميركي كنواة لمجمع أبحاث نووية أكبر.
وذكر خطاب لمسؤولي مشروع الأبحاث النووية عام 1956 عن “تحديث” مفاعل الأبحاث الأميركي، من أجل “اكتساب خبرة أكثر تقدماً في فصل البلوتونيوم”، وفقاً لـ”مؤسسة التراث الذري”.
وكان من الواضح أن هذه المساعدة الأميركية المحدودة لن تكون كافية لتطوير برنامج نووي ذي شأن، وسرعان ما طُرحت فرنسا بوصفها الحليف الأقدر على “مد يد المساعدة”، إذ أمن بيريز الحصول على دعم باريس للبرنامج النووي الإسرائيلي، على الرغم من أن برنامج فرنسا النووي نفسه كان لا يزال في طور تشييد شبكة مترامية الأطراف من المفاعلات النووية في أنحاء البلاد.
ويتذكر الكيميائي برتران جولدشميدت، وهو الفرنسي الوحيد الذي عمل في “مشروع مانهاتن” لإنتاج أول قنبلة نووية أميركية، اجتماعاً سرياً عُقد في سبتمبر 1956 بين ممثلي الحكومتين الفرنسية والإسرائيلية، اتفقوا خلاله على “توسيع القدرات النووية الإسرائيلية”، على أن يظل الأمر سراً محصوراً على أضيق نطاق بين المسؤولين المعنيين، إذ لم تشأ باريس إثارة مشاعر عدائية تجاهها في العالم العربي، كما خشي الطرفان أن تتحفظ واشنطن، وتفرض قيوداً على البرنامج النووي الإسرائيلي، تغليباً لاعتبارات منع الانتشار النووي.
وبعد شهر واحد من هذا الاجتماع، شنت بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل، “العدوان الثلاثي” على مصر رداً على قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، وفيما أجبرت واشنطن “قوى العدوان” على إنهاء الحرب والانسحاب من شبه جزيرة سيناء، إلا أن تلك الحرب أعطت دفعة قوية للتعاون النووي الفرنسي الإسرائيلي، وساهمت في رفع مستوى الدعم المقدم للبرنامج النووي الإسرائيلي من باريس.
وشرعت فرنسا عام 1957 ببناء مفاعل نووي بطاقة 24 ميجاواط لإسرائيل، واشترت تل أبيب من النرويج 20 طناً من الماء الثقيل اللازم لسلسلة التفاعلات النووية، كما ساعد مهندسون فرنسيون في تشييد منشأة النقب للأبحاث النووية قرب ديمونة في صحراء النقب.
وبحلول نهاية الخمسينيات كان هناك نحو 2500 فرنسي يعملون في تخصصات مختلفة يقيمون سراً في ديمونة، وكان محظوراً عليهم مراسلة أقربائهم ومعارفهم مباشرة، إذ كان بريدهم يُرسل إلى عنوان بريدي وهمي في أميركا اللاتينية.